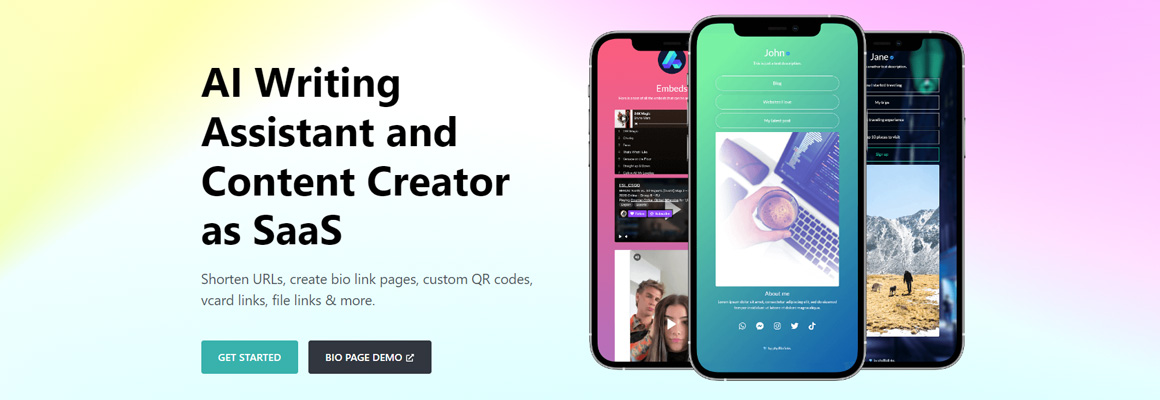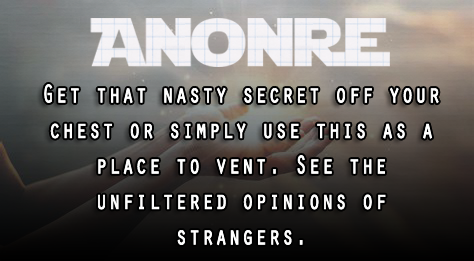تفسير سورة يونس (الحلقة الثالثة)
أربعُ سُبُلٍ هنَّ إلى النار أقرب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه تفسير السور الْمِئينَ من كتاب رب العالمين.
قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 7 – 14].
عندما بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولَّ أمرِهِ، واجه قومًا في طبعهم شدة وجفاء وعدوانية، إن خُولِفوا أو خالفوا، وصدقٌ وإقبال، ونُصرة ووفاء، إن صدَّقوا وآمنوا، تركيبتهم النفسية والاجتماعية بذلك بيِّنة واضحة، ليس فيها نفاق، ومواقفهم حادة في حبِّهم وبُغضهم، ونصرتهم وعداوتهم، فكان منهم المؤمنون الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبروا على ظلم قومهم وأذاهم، وصابروا فكفُّوا أيديهم وألسنتهم عن المشركين إذ أُمِروا بكفِّها، واستبشروا فرحين بما بشَّرهم الله به في قوله عز وجل: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: 2]، وكان منهم من أعرض وكفر، وأنكر البعث والنشور، والحساب والجزاء، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [يونس: 2]، لذلك واصل الوحيُ الكريم بيانَ حال هاتين الطائفتين في مكة، ومآلَ من يسيرُ بسيرةِ أيٍّ منهما من الجن والإنس في الحياة الدنيا، بعد أن أكَّد وعده الصادق في مستهل هذه السورة؛ سورة يونس المباركة؛ بقوله عز وجل: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ [يونس: 4]، مبتدئًا بمن أنكر الربوبية، والنبوة، واليوم الآخر، وما أنزل من الوحي، مجملًا حالهم في أربع حالات؛ أولها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس: 7]، والفعل ﴿ يَرْجُونَ ﴾ [يونس: 7]، من: “رجا يرجو رجاء”، والراء والجيم والحرف المعتل كما قال ابن فارس في معجمه أصلان متباينان، أولهما “الرجا” مقصور، جمع أرجاء، وهو الناحية؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ﴾ [الحاقة: 17]، والثاني: “الرجاء”؛ وهو الأمل والتمني، والترقُّب، نقيض اليأس، فيُقال: رجوت الأمر أرجوه رجاءً، ورجاوةً، ومَرجاةً، ورجاةً، ورَجْوًا، إذا تمنَّيتُه وأملتُه ورغِبتُ في وقوعه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: 60]؛ أي: لا يُرِدْنَهُ، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات؟ قال: نعم، فقال: بَخٍ بَخٍ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك: بَخٍ بَخٍ؟ قال: إلا رجاةَ أن أكون من أهلها))؛ أي: رغبة في دخولها، كما أن الرجاء قد يعني الخوف في بعض السياقات الأخرى؛ مثل قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ [نوح: 13]؛ أي: لا تخافون قوته، ولا خطورة الكفر به.
لقد بُدِئت هذه الآية الكريمة بحرف ﴿ إِنَّ ﴾ [يونس: 7]، الذي يدخل على الجملة الاسمية، فيؤكدها، وينصب مبتدأها، ويرفع خبرها، والاسم الموصول ﴿ الَّذِينَ ﴾ [يونس: 7]، اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وقوله تعالى: ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس: 7]، من الفعل والفاعل والمفعول به جملة الصلة، ولقاء الله لهم تعبير مجازي عن سؤال الله لهم ومحاسبتهم يوم القيامة، والآية في مجملها تعريض بحال كفار مكة، وإشارة إلى كلِّ مَن يُنكر البعث والنشور، والجنة والنار، ولا يرتقب حسابًا أو جزاء، ولا يؤمن بهما، أو إلى كل من لا يخاف الله، ولا يخشى حسابه وعقابه، كحال معاصرينا من الملاحدة والدهريِّين، والروحيِّين والطبيعيين، وكل من لا يتصور وجود إله للكون مطلقًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: 4، 5]، وقوله عز وجل: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الجاثية: 24، 25]، كل هؤلاء وَصَفَ الحق تعالى حالهم الْمُنْذِرَ بسوء المصير في الآخرة بقوله: ﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس: 7]؛ أي: لا يؤمنون بيومٍ يَلقَون فيه ربهم تعالى، ولا يخافونه، ولا يترقَّبون أو يظنون ﴿ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: 4 – 6]، ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ [الانفطار: 19]، وعلى رأسهم كفار قريش، الذين كانوا يكرهون سماع القرآن إذا تُلِيَ عليهم مباشرة، فيعتَدُون على من تلاه عليهم من المسلمين، أو تلاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرم في خلواته أو أثناء الصلاة، فيقولون له: ﴿ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ [يونس: 15].
ثم أضاف الحق تعالى إلى هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولا يحسِبون لها حسابها صفةً ثانية لهم؛ فقال عز وجل: ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [يونس: 7]، والفعل: “رضوا”، من: رضِيَ يرضَى رضًا ورِضاءً، وهو راضٍ، ومَرضِيٌّ عنه، والرضا لغة: شعور المرء بالارتياح إلى شيء ما، مشوبًا بحبِّه وإرادته، وضده البُغض والسَّخَط والنفور من الشيء، ورضاء المشركين بالحياة الدنيا هو إعجابهم بها، وميلهم إليها، ومحبتهم لها، وإيثارهم لها على ما سواها، وحرصهم على تحصيل زينتها، واستدامة مفاتنها؛ قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: 14]، وتلك هي الخِصال القاتلة للنفوس، المحبِطة للأعمال، الْمُرْكِسَة في نار جهنم؛ قال تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم: 2، 3]، وقال عز وجل: ﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: 51]، وقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: 37 – 39]، وتلك هي الآفات التي يعاني منها المجتمع المسلم المعاصرُ؛ انبهارًا منه بالحياة الغربية العلمانية التي رضِيَت بالحياة الدنيا، ولا ترجو لقاء الله، ولا تقيم للآخرة وزنًا؛ قال تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم: 2، 3]، وقال عز وجل: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: 86]، وقال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: 37 – 39].
ثم أضاف عز وجل خَصلة ثالثة؛ هي تمام الضلال، ومنتهى الإعراض عن الهداية؛ وقال سبحانه: ﴿ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ﴾ [يونس: 7]، ركنوا إليها، وسكنت لها قلوبهم، وتعلقت بملذاتها وشهواتها نفوسُهم، فسعِدوا بها، وظنوا أنما هي حياة واحدة ووحيدة، فآثَرُوها على ما لا تراه أعينهم: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: 24]، ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: 29].
وخصلة رابعة هي الغفلة عن آيات الله؛ بقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ [يونس: 7]، استغرقت حواسَّهم الغفلةُ، فانصرفوا عن سماع آيات الله في القرآن الكريم وتدبُّرها، وعن رؤية آياته الكونية في السماء والأرض، وحكمة خلقها وتسخيرها.
هذه الآفات الأربعة؛ عدم استحضار يوم لقاء الله، والرضا بالدنيا وعنها والفرح بها، والاطمئنان إليها، والغفلة عن تدبر آيات الوحي المسطور والكون المنظور، هي التي أعْمَتْ كفار قريش من قبلُ عن الحقِّ، وصرفتهم عن الإيمان، وهي التي أطاحت من بعدُ بمَجْدِ المسلمين، وما نالوه من عزٍّ وسُؤدَدٍ، وما أقاموه من حضارة، وصرفتهم حاليًّا عن محاولة بناء الدنيا من أجل الآخرة، لذلك كان غضب الله لهذه الآفات شديدًا، وعقابه للمتلبسين بها أشدَّ؛ فقال بيانًا للعاقبة وتحذيرًا منها: ﴿ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ [يونس: 8].
والجملة الاسمية من المبتدأ ﴿ أُولَئِكَ ﴾ [يونس: 8]، والخبر ﴿ مَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ [يونس: 8]، في محل رفع خبر ﴿ إِنَّ ﴾ [يونس: 7]، في قوله تعالى من قبل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس: 7]، أي: أولئك الذين لم يؤمنوا بالآخرة بعثًا ونشورًا، وحسابًا وجزاء، وجنةً ونارًا، ورضوا بالحياة الدنيا وزينتها، وأعرضوا عن تدبُّرِ كتاب الله وآياته في الكون، ولم يعُدُّوا للآخرة عِدَّتها، إيمانًا راسخًا، وعملًا صالحًا، وعبادة خالصة، ليس لهم عند الله إلا نار جهنم، وعلَّل الحق سبحانه عقابه لهم فقال: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: 8]، وحرف الباء في الآية للجزاء والمقابلة بين ما فعلوه في الدنيا، وما انتهَوا إليه في الآخرة، والتعبير بصيغة الماضي في ﴿ كَانُوا ﴾ [يونس: 8] مقرونًا بصيغة المستقبل في ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: 8] يفيد استمرار عذابهم، ودوام خلودهم في النار، جزاءً عادلًا لِما اكتسبوه في الدنيا من آثامِ الكفر، والرضا من الحياة بأهون ما فيها، والإقبال على الآخرة بأسوأ ما ينتظرهم منها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الحج: 10].
وبعد أن ذَكَرَ سبحانه بخواتم السوء لدى الكفار والمشركين، بيَّن خواتم الحسنى لدى المؤمنين، بشارةً لهم، وتحريضًا لغيرهم على اتباع نهجهم في الإيمان والإحسان؛ فقال عز وجل:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [يونس: 9]، بالله ورسوله، وما نزل من القرآن، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [يونس: 9]، أضافوا إلى الإيمان العملَ بمقتضاه في عباداتهم وعلاقاتهم، ومعاملاتهم سرًّا وعلانية، ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ [يونس: 9]، يهديهم الله جزاءَ تصورهم الإيمانيِّ السليم، وعملهم الصالح المقبول، إلى سبيل الجنة الْمُعَدَّة لهم، فيدخلونها؛ قال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69]، يدخلونها بفضل الله، بين نعيمٍ لا ينفَد، وسعادة لا تستنفد، ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: 9]، بين أنهارها وجِنانها؛ حيث لا موت ولا فناء، ولا حزن ولا شقاء؛ قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [محمد: 15]، وقال عز وجل: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ [الرعد: 35]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمِعت، ولا خَطَرَ على قلب أحد)).
ثم وصف تعالى سعادتهم النفسية، واطمئنانهم في الجنة، وانبهارهم بها؛ فقال سبحانه: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا ﴾ [يونس: 10]، دعاؤهم فيها الشكر لربهم على ما هدى، وما غفر، وما أعطى، وترديدهم ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ [يونس: 10]، هو تسبيحهم فيها وذِكْرُهم، ﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [يونس: 10]، شعارهم فيما بينهم بالجنة السلام، ولا يسمع بعضهم من بعض إلا السلام، ولا يعم فيهم إلا الأمن والرفق والمحبة، وليس للعنف أو القتل أو العدوان فيما بينهم وجود، ولا في نفوسهم أو معاملاتهم منه أثر، لا يخاطب بعضهم بعضًا إلا بما تطمئن به نفوسهم، حتى ملائكة الرحمن لا يترددون عليهم إلا بالسلام؛ قال تعالى: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: 23، 24]، ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ ﴾ [يونس: 10]، وخاتمة دعائهم كلما سألوا ربهم شيئًا، فعجَّل لهم به: ﴿ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: 10] على ما هداهم إليه في الدنيا، وما أكرمهم به في الآخرة، خلافًا لحال المشركين في جهنم، ودعائهم، فلا يُستجاب لهم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: 49، 50]، وقال عز وجل: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [الزخرف: 77].
إن الدعاء في الآخرة يُنجَز القضاء فيه أسرع من لمح البصر، فيُعجَّل للمؤمن ما سأل في الجنة، ويُعجَّل للكافر في النار الرفض، وما ذلك إلا لأن الفريقين تجاوزا دار الاختبار والبلاء في الدنيا، وانتهيا إلى دار الجزاء في الآخرة؛ وقد نُودِيَ فيهم: ((يا أهل الجنة، خلود لا موت، يا أهل النار، خلود لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم)).
أما في الدنيا – وهي دار اختبار وبلاء، وإعدادٍ ليوم الفصل والجزاء – فإن لدعاء المرء نظامًا آخرَ يُناسب استمرار الحياة فيها، بما قدَّره الله لها بحكمته وعلمه وقدرته، لا يُعجَّل لعَجَلَةِ أحدٍ ولا يُبطَّأ ببطئه، ولئن كان الكفار يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجلين الإجابة، بقولهم له تحدِّيًا: ﴿ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ [يونس: 15]، وقولهم تعجيزًا: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 90 – 93]، وكان بعض المؤمنين عندما اشتد أذى الكفار بهم، يعجبون لإمهال الله لهم، حتى إن بعضهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استعجالًا للنصر: ((ألَا تستنصر لنا؟ ألَا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يُؤخَذ الرجل فيُحفر له في الأرض، فيُجعل فيها، فيُؤتى بالمنشار، فيُوضع على رأسه، فيُجعل بنصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد فيما دون عظمه ولحمه، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله لَيَتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَموتَ، لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون))، فإن الله عز وجل قد ردَّ على الفريقين ببيان حكمته في تصريف أمر خلقِهِ، بما يعلمه ويقدِّره ويحكمه، لا بما يراه غيره، أو يقدره، أو يحبه، وسُنَّتُه في إمهال العقوبة أو التعجيل بها؛ تثبيتًا للمؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، وإفساحًا لفرص التوبة أمام العصاة رحمةً بهم، وإشفاقًا عليهم، وإمهالًا لهم؛ بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: 11].
ولفظ ﴿ الشَّرَّ ﴾ [يونس: 11]، في هذا السياق من الآية الكريمة معناه عقوبة الذنب؛ أي: لو أن كل امرئ أذنب، استعجل الله له العقوبة في الحياة مباشرة، ﴿ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ﴾ [يونس: 11]، كما هي عادة الناس في استعجالهم الحصولَ على الخيرات في حياتهم العامة من تجارة، وزراعة، ومعاملات عامة وخاصة، ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: 11]، لاختُزِلت حياتهم، وهلكوا من ساعتهم، وانتهت الحياة في الأرض بانتهائهم؛ ولذلك قُرِئَ قوله تعالى: ﴿ لَقُضِيَ ﴾ [يونس: 11]، بضم القاف، وكسر الضاد، مبنيًّا للمجهول، ورُفِعَ ﴿ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: 11] نائبًا للفاعل، إشارة إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى، وقرأها عوف وعيسى وابن عامر ويعقوب: ﴿ لَقَضَى ﴾، مبنيًّا للمعلوم، بفتح القاف والضاد، وفَتْحِ ﴿ أَجَلَهُمْ ﴾ مفعولًا به؛ أي: لقضى الله أمره فيهم بالعقوبة، وما أُمْهِلوا طرفةَ عين؛ كما في قوله عز وجل ﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ﴾ [الحجرات: 7]، لو يستجيب لكم في كثير مما تستعجلونه به، لَتَعِبْتُم بسوء نتائج اختياراتكم وتقديراتكم وقراراتكم، ولكنَّ لله آجالًا مُقدَّرة، وحِكَمًا مُقرَّرة، لا يَعْجَل لعَجَلَةِ خَلْقِهِ، ولا يُبطِّئ لتَبْطِئتِهم؛ ولذلك عندما قالت أم حبيبة[1]: ((اللهم بارك لي في زوجي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أبي سفيان، وأخي معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتِ الله عن آجال مضروبة، وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة، لا يُعجَّل منها شيء قبل حلِّه، فلو سألتِ الله أن يُعيذكِ من عذاب النار، أو عذاب القبر، كان خيرًا، أو كان أفضل))، ومن هذه الآجال المضروبة للخلق في الدنيا ولا بد للناس من بلوغها أنه سبحانه يُمهل الكافر الذي لا يرجو لقاءه، ويُرجِئه إلى الأجل المضروب له؛ بقوله عز وجل: ﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس: 11]، من كفار قريش ومن غيرهم في كل عصر، لا نُعجِّل عقوبتهم، ونتركهم ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾ [يونس: 11]؛ في ضلالهم، ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: 11]؛ يَتِيهون ويتخبَّطون.
كان هذا حال فئة من قريش لا يؤمنون بالآخرة، ولا يرجون لقاء الله، كلما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العقوبةَ، تحدَّوه، واستعجلوها صَلَفًا واستكبارًا، وتكذيبًا واستبعادًا، كما فعل قوم صالح إذ عقروا الناقة تحدِّيًا له، واستخفافًا بما هدَّدهم به: ﴿ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: 77]، وهذا دَيدَنُ كل الكفار في كل عصر، كلما دُعُوا إلى الحق، استعْلَوا بالباطل؛ ولذلك عقَّب عز وجل ببيان هذه الظاهرة في سلوك بني آدم محذِّرًا منها بقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ﴾ [يونس: 12]؛ أي: إذا أصاب أحدًا منهم ضررٌ أعجزه وأضناه في نفسه، أو ولده، أو أهله، تذكَّر بفطرته الأولى ربَّه، ﴿ دَعَانَا ﴾ [يونس: 12]، سأل ربه عز وجل، ﴿ لِجَنْبِهِ ﴾ [يونس: 12]، مُتَّكِئًا، ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ [يونس: 12]، جالسًا أو واقفًا، وفي أي حالة من حالاته، ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ﴾ [يونس: 12]، فلما أذهب الله عنه ما أصابه، ﴿ مَرَّ ﴾ [يونس: 12]، نسِيَ ما أصابه ومَن كَشَفَ عنه الضرر، وانصرف إلى ممارسة كفره، والإغراق في عداوته لله ورسوله والمؤمنين، ﴿ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ﴾ [يونس: 12]، كأنه لم يلجأ مرة إلى الله اضطرارًا، ولم يستَجِبْ له في ضائقة قطُّ، هذه سيرتهم دائمًا، في حالة ضعفهم يلجؤون إلى الله، وفي حالة قوتهم أو شعورهم بالقوة يتمرَّدون ويحاربون، ويبالغون في الجحود والعداوة، ﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 12]، والإسراف لغة من فِعْلِ “سَرَفَ”، والسين والراء والفاء كما قال ابن فارس في معجمه أصلٌ واحد، يدل على تعدي الحدِّ في شيء، وإغفال غيره، فتقول: أسرف في إنفاق ماله، وأغفل الادخار لبعض أحواله، وأسرف في العمل للدنيا، وأغفل العمل للآخرة؛ ومنه ما رواه البخاري من قول ابن عباس: “كُلْ ما شئت، والبَس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سَرَفٌ ومَخِيلَةٌ”؛ أي: هكذا زين الشيطان للمسرفين المبالغين في عداوتهم لله ورسوله ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 12]؛ أي: ما كانوا يرتكبونه من آثام الكفر والجحود والعدوان، والتحدي لآيات الله المذكِّرة بلقائه، والمحذِّرة من غضبه وعذابه، والكاشفة لقدرته في الأرض وفي السماء، كحالهم بالتشكيك في انشقاق القمر فلقتَينِ، إحداهما على جبل أبي قبيس، والثانية على جبل قُعَيْقِعان؛ وقد قال تعالى عنه: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القمر: 1 – 3]، وقال ابن مسعود عنه: ((بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنًى، فانشق القمر فلقتين: فلقة من وراء الجبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا))[2]، وما سبق من إسرائه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؛ قال عنها تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: 1]، ولذلك اقتضى حالهم هذا تذكيرهم وتحذيرهم، وتهديدهم بأحداث أشدَّ خطورةً ما زالت تُنقَل إليهم أخبارُها متواترةً من جيل إلى جيل، وقعت قريبًا منهم في مجتمع الجزيرة العربية وما حولها، وقد يتكرر وقوعها فيهم إن لم يؤمنوا؛ فقال تعالى بالتفاتٍ بيانيٍّ من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطبين: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [يونس: 13]، والقرون في هذا السياق جمع قرن، يُطلَق على الأمة من الناس يعيشون في زمن واحد وأرض واحدة؛ أي: أهلكنا أُمَمًا وأقوامًا بذنوبهم على مدار الأزمان السابقة المتتالية؛ كما قال تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا * وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا * وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴾ [الفرقان: 37 – 39]، ذكَّرهم الله تعالى بتلك الأقوام التي طَغَت، وكذَّبت الرسلَ، فأهلكها في الدنيا، مع ما ينتظرها من عذاب الآخرة، وبيَّن متى أصابهم الهلاك وسببه؛ فقال عز وجل:
﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ [يونس: 13] و﴿ لَمَّا ﴾ في رأس الآية ظرف تضمَّن معنى الشرط بمعنى حين؛ أي: حين ظلموا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف: 59] والظلم لغة من أصلين صحيحين؛ أحدهما خلاف الضوء والنور، ومنه الظلمة والظلام، وما يمنع الرؤية ويسُدُّ البصر؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: 40]، والأصل الثاني معناه وضع الشيء في غير موضعه، كمن يضع زكاته في غير مصارفها فيظلم، ونطفته في غير حِلِّها فيظلم، وركوعه أو سجوده لغير الله فيظلم ويُشرك، وهو المعنى المقصود من الآية الكريمة، وضده العدل الذي تُقام به محكمة الحقوق يوم القيامة على أكمل وجه، فيقتص للمظلومين جنًّا وإنسًا وعجماواتٍ من ظالميهم، سادةً حاكمين كانوا أو عامَّةً محكومين؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لَتُؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد للشاة الجَلْحاء من الشاة القَرْناء))[3]، وقال: ((عُذِّبت امرأة في هِرَّةٍ سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها، ولا سقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض))[4].
إن ميزان الآخرة منضبط على معيار واحد يُميِّز العدل من الظلم؛ قال عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [غافر: 17]، عدلٌ يُنجِّي، وظلم يُركِس في الجحيم؛ لذلك وَرَدَ الأمر بالعدل، والتحذير من الظلم قرآنًا وسُنَّة في سياقاتٍ كثيرة، وبأشد الصيغ دقة ووضوحًا؛ فقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]، وقال: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ [الصافات: 22 – 24]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]، وقال فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: ((يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا))[5]، وقال صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع: ((… فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ؛ فإن الشاهدَ عسى أن يُبلِّغ من هو أوعى له منه))[6].
إن التحريم الصارم للظلم مَبْعَثُهُ العدلُ الإلهيُّ الْمُطْلَقُ، والرحمة الربانية الشاملة؛ لأن الظلم مصدر كل رذيلة، ومنبع كل شرٍّ، وما الفساد إلا بعض نتائجه؛ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: 205]، وما البغي إلا بعض ثماره؛ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [يونس: 23]، وقد استُعمِل لفظ “الظلم” في كلام الشارع لثلاثة أصناف، تدور كلها بين الكفر والكبائر؛ هي:
ظلم بين المرء وبين الله تعالى، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق؛ قال تعالى: ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13]، وقال عز وجل: ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 258].
وظلم بين المرء وبين الناس؛ قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: 42]، ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ﴾ [الإسراء: 33].
وظلم بين المرء وبين نفسه؛ قال تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [فاطر: 32]، وقال عز وجل: ﴿ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: 36]، والأصل في هذه الأصناف كلها ظلم النفس؛ إذ كل ظالم في حقيقة الأمر ظالم لنفسه، وكل محسنٍ محسنٌ لنفسه: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: 46]، ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: 7]؛ لأن عاقبة تصرفات المرء تعود عليه جزاءً وفاقًا في الآخرة: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: 123]، ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: 118].
لذلك كان من عدل الله سبحانه في عباده أن يُبيِّن لهم أسباب هلاك القرون قبلهم؛ فقال عز وجل: ﴿ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ [يونس: 13]، بدلائل توحيده عز وجل، ووجوب عبادته، وطاعة رسله، والعمل بما أنزل عليهم من الأحكام والشرائع، ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ [يونس: 13]، وما كان لهم استعداد أو رغبة في الإيمان؛ استغناء عنه، وتكذيبًا بمن بُشِّر به، وفرحًا بما لديهم من الدنيا، ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: 13]، بمثل هذا المصير في الدنيا والآخرة يجزي الله كلَّ مَن أجرم في حقه بالكفر، وحقِّ رسله بالتكذيب والاضطهاد والعدوان، يُهلكهم، ويجعلهم آيةً للعِظة والاعتبار.
ولأن من سُنَّة الله التي قدَّرها للأرض أن تستمر الحياة البشرية فيها إلى يوم الدين، كلما هَلَكَ قرنٌ، خَلَفَهُ قرن من نسله، فإن كفار قريش كانوا مجرد نسل لمن هلك من القرون قبلهم؛ ولذلك خاطبهم الله مذكِّرًا بحقيقة وجودهم، ومحذِّرًا من عاقبة من كان قبلهم بقوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [يونس: 14]، ولفظ ﴿ خَلَائِفَ ﴾ [يونس: 14]، من “خلف يخلُف”، جذره اللغوي مادة “خلف”، والخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: الأول: خلاف قُدَّام، كقولك: هذا خلفي، وهذا قدامي، والثاني: التغيُّر، كقولهم: خَلَفَ فُوهُ، إذا تغيَّر؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَخُلُوف فمِ الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك))، والثالث: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، ومن هذا الأصل قولهم: هو خَلَفُ صِدقٍ من أبيه، وخَلْفُ سَوءٍ من أبيه، فإن لم يذكروا صدقًا ولا سوءًا قالوا للجيد: “خَلَف” بفتح اللام، وللرديء “خَلْف” بسكون اللام، وخلائف جمع خليفة، جاؤوا به على أصل تأنيثه اللفظي؛ مثل: كريمة جمع كرائم، وقطيفة قطائف، وجمعوه أيضًا على خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء، فجمعوه على إسقاط الهاء؛ مثل: ظريف جمعه ظرفاء، ثم نُقِل لفظ “الخليفة” بنوع من التعسُّف إلى معنى رئاسة الدولة والولاية العامة على الأمة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، عندما خاطبه أحدهم بلقب “خليفة الله”، فاعترض على ذلك؛ لأن الخلافة لا تكون إلا عن غائب، والله تعالى لا يغيب، ثم استُعِيض عنه بمصطلح “خليفة رسول الله”، ولأن النبوة معصومة، ولا يسُدُّ مَسدَّها أحد، ولا معصومَ غيرُه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر نفسه انتبه إلى هذا عندما خاطب المسلمين قائلًا: “أيها الناس، إنما أنا مثلكم، وإني لعلكم تكلِّفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُطيق”، فقد استُعيض عن هذا اللقب في عهد عمر رضي الله عنه بمصطلح “أمير المؤمنين”، الذي ارتاحت له فطرة المسلمين، ثم مع فُشُوِّ علوم التفسير، ونشوء الملك العَضُوض لدى المسلمين، أبعد النُّجْعَة بعضُ المفسرين، فجعلوا الإنسان خليفةً لله في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، كما هو واضح من كلام الطبرسي – من الشيعة الإمامية – في (مجمع البيان) في قوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30]: “أي: خالق في الأرض خليفة؛ أراد بالخليفة آدم عليه السلام، فهو خليفة الله في أرضه يحكم بالحق”، ومما ذهب إليه القرطبي إذ استعرض في كتابه (الجامع لأحكام القرآن) مختلِف التأويلات المتداولة حول لفظ “خليفة”، ولكنه تبنَّى في النهاية نظرية “الخلافة عن الله”؛ بقوله[7]: “والمعنيُّ بالخلافة هنا في قول ابن مسعود، وابن عباس، وجميع أهل التأويل آدمُ عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره…”، ثم لم يكتفِ بهذا القدر، بل وظف هذا التأويل سياسيًّا، وجعله قاعدة عامة لنظام الحكم؛ بقوله[8]: “هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمَع له ويُطاع لتجتمع به الكلمة، وتُنفَّذ به الأحكام، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأئمة، إلا ما رُوِيَ عن الأصم…”، مع أن الاستخلاف في الأرض مجرد استمرار لوجود الإنسان فيها، وتداول له على عمارتها، جيلًا بعد جيل، وقرنًا بعد قرن؛ ابتلاءً من الله له، واختبارًا وإعدادًا ليوم الدين؛ قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران: 140]، وهو ما خُوطِبَ به كفار قريش ومشركوها؛ إذ ذكَّرهم القرآن بهلاك القرون قبلهم، وحكمة استخلافهم من بعدهم؛ بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: 14]؛ أي: استخلفكم بعد الأمم قبلكم، وأرسل إليكم الآيات تَتْرَى؛ كونيةً كانشقاق القمر، ووحيًا هو القرآن الكريم، ونبيًّا رسولًا هو محمد صلى الله عليه وسلم، بشارة ونذارة، وأحكامًا شرعية تنظِّم حياتكم، وعِبَرًا في أنفسكم وفي غيركم، ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: 94].
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.