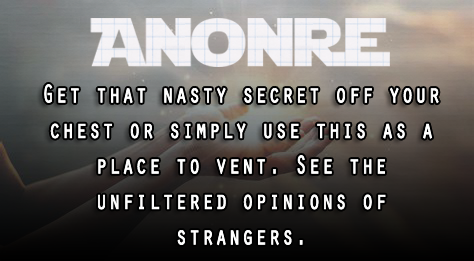حال العرب قبل الإسلام
فقد كانت الحقبة قبل الإسلام تعرف بالجاهلية مع ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ، فمن الناحية الدينية فقد انتشرت عبادة الأصنام في جزيرة العرب، حتى صار لكل قبيلة صنم، بل في كل بيت منها صنم، يقول الصحابي أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: “كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه، ألْقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به”؛ (رواه البخاري).
وغير الأصنام كان للعرب آلهة أخرى؛ منها: الملائكة والجن والكواكب، فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله، فيتخذونهم شفعاءَ لهم عند الله، ويعبدونهم، ويتوسلون بهم عند الله، واتخذوا كذلك من الجنِّ شركاءَ لله، آمنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم[1].
وفضلًا عن ذلك كانت اليهودية منتشرة في بلاد العرب، وقد صار رؤساؤها أربابًا من دون الله، يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة، وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر، وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسيرة الفهم، وأوجدت خلطًا عجيبًا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بها تأثير حقيقي[2].
• ومن ناحية الأخلاق فقد كان شرب الخمر واسع الشيوع، شديد الرسوخ فيهم، حتى إنها شغلت جانبًا عظيمًا من شعرهم وتاريخهم وأدبهم، وكذا انتشر الميسر، قال قتادة [3]: “كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله، فيقعد حزينًا سليبًا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورِّث بينهم عداوة وبغضًا”[4].
• كما كان التعامل بالربا فاشيًا بين العرب واليهود، وقد رسخ فيهم، حتى قالوا: إنما البيع مثل الربا، وانتكست الفطرة كذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة؛ حيث بات الزنا من العادات المألوفة، فكان الرجل يتخذ خليلات وتتخذ النساء أخلاءَ بدون عقدٍ؛ تقول عائشة – رضي الله عنها – كما عند البخاري: “إنَّ النِّكاحَ في الجاهليَّةِ كانَ على أربعةِ أنحاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ أو ابنته فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها، ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأته إذا طهُرَت من طمثِها: أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ، ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ، فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إذا أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ، فكانَ هذا النِّكاحُ نكاحَ الاستبضاع، ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ ما دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها، فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها، تقولُ لهم: قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم، وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ، فتسمِّي من أحبَّت باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل، ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تكون علمًا، لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ[5] ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاط بهُ[6] ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ “.
وبالنسبة إلى وضع المرأة فقد لخَّصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: “وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ”؛ (رواه البخاري).
ولم يكن للمرأة حق الإرث، وكانوا يقولون في ذلك: “لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة”، فإذا مات الرجل ورثه ابنه، فإن لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه، أبًا كان أو أخًا أو عمًّا، على حين تُضمُّ بناته ونساؤه إلى بنات الوارث ونساؤه، فيكون لهنَّ ما لهنَّ، وعليهنَّ ما عليهنَّ، ولم يكن لها على زوجها أي حق، وليس للطلاق عدد محدود، ولا لتعدد الزوجات عدد معين، وكانوا إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه من غيره، فهو يعتبرها إرثًا كبقية أموال أبيه[7].
• هذا وقد بلغت كراهية البنات إلى حد الوأد، فكان وأد البنات من أشنع العادات في الجاهلية، وإذا نجت الوليدة العربية من الوأد وجدت غالبًا في انتظارها حياة ظالمة، وقد عبَّر القرآن الكريم عن ذلك فقال تعالى: ﴿ وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: 58-59].
وهكذا كان الوضع في الجزيرة العربية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• ويقول أبو بكر الجزائري – رحمه الله – في كتابه “هذا الحبيب يا محب ص 31، 32”:
“ومن جملة العادات السيئة التي بالمجتمع العربي قبل الإسلام:
1- القِمَار والمعروف بالمَيْسِر، وقد حرَّمه الإسلام بآية سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].
2- شرب الخمر: والاجتماع عليها، والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنها.
3- نكاح الاستبضاع: وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر، فيطلب لها أشراف الرجال من أجل أن تنجب ولدًا يرث صفات الكمال التي يحملها أولئك الواطئون لها.
4- وأد البنات: وهو أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية في التراب خوف العار.
5- قتل الأولاد مطلقًا ذكورًا كانوا أو إناثًا: وذلك عند وجود فقر شديد.
6- تبرُّج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارة بالرجال الأجانب، متغنجة في مشيتها متكسِّرة، كأنها تعرض نفسها وتغري بها غيرها.
7- اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال.
8- إعلان الإماء عن البغي بهن، وذلك بأن تجعل إحداهنَّ راية حمراء على باب منزلها لتعرف أنها بغي ويغشاها الرجال.
9- العصبية القبلية.
10- شن الغارات والحروب على بعضهم بعضًا للسلب والنهب، ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء وحرب بُعاث، وحرب الفجار…”؛ اهـ.
• وهكذا كان حال العالم قبل الإسلام؛ حيث وصل حال الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله تعالى؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِن اللهَ نظر إلِىَ أهْلِ الْأَرْضِ، فمقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ، إِلا بقَايَا من أهْلِ الْكِتَابِ”.
• وقد فصَّل ذلك أبو الحسن الندوي حين قال: “وبالجملة لم تكن على ظهر الأرض – قبل بعثة الرسول أمة صالحة المزاج، ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة، ولا حكومة مؤسسة على أساس العدل والرحمة، ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء”[8].
فالأحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسْره، وقد عمَّ الفساد كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية على السواء، وباتت الدنيا في ظلام دامس، لا يحكمها إلا الجهل الذي أغرقها في بحر متلاطم من الخرافات والأوهام، ولا يُسَيِّرُها إلا الشهوات والأطماع، فعبد الناس الأحجار والشمس والقمر والنار حتى الحيوان، وانقسموا إلى سادة وعبيد، وقد أكلوا مال اليتيم، وقطعوا الأرحام، وقامت معاملاتهم على القتل والسلب والنهب، كما افتخروا باقتراف الفواحش والآثام، فليس هناك شريعة تحكم، اللهم إلا شريعة الغاب، فالقوي يأكل الضعيف، والغني يستعبد الفقير، والكل في ظلام لا يجدون معه نهاية ولا مخرجًا.
• وقد ظَلَّ ذلك الوضع المتردي إلى أن بزغ فجر الإسلام بنوره، فبدَّد ظلمات الجهل والتخلف والانهيار الأخلاقي التي سادت العالم، وكشف زيف الخرافات، وزرع في النفوس الحب والسلام، والتواضع والإيثار، والعدل، ومحبة الخير، والتفاني في نشره، ونهى عن الشرك، والسرقة، والقتل، وقطيعة الرحم، والزنا، والخنا والفجور، والظلم، وهضم حقوق الغير حتى لو كان من غير المسلمين.
• قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي عندما سأله عن هذا الدين الجديد؛ (أي الإسلام): “أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، ويَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنْ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ،…- فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الإسلام – فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا….”. الحديث “؛ (رواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الاعتقاد، ورواه ابن هشام في سيرته بسند صحيح).
فكان ظهور الإسلام بمنزلة منارة أُضيئَتْ، فبدَّدت ظلام ليلٍ خيَّم على عالم مليء بالظلم والظلمات وشتى أنواع المخالفات، فاستحق الإسلام أن يكون منهج حياة، لِمَ لا وهو من تشريع رب العالمين، خالق الناس أجمعين، ويعلم ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم!
فالإسلام ربَّـاني المصدر، وهذا يضفي عليه من القدسية والهيبة والاحترام والتوقير والقبول بخلاف القوانين الوضعية، فليس لها سلطان على النفوس، ولذلك يصحب القوانين الوضعية ذكر فوائدها وعواقب مَن يخالفها، لكن مع ذلك تجد مَن يخالف، حتى يفشل القانون بعد فترة وجيزة ويأتون بقانون جديد… وهكذا، وقانون اليوم لا يصلح لغَدٍ، بخلاف الإسلام الذي يصلح لكل وقت وفي أي مكان، وكونه رباني المصدر، فهو بهذا يهدف إلى ربط الناس بخالقهم.
• ويُعَدَّ القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية المطهرة أصل ومصدر التشريع الإسلامي، فأما القرآن الكريم فهو كتاب الله المجيد المُنَزَّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ قال عنه الله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:1]، وهو كتاب أمثاله عِبَرٌ لمن تدبرها، وأوامره هدى لمن استبصرها، شرح الله فيه واجبات الأحكام، وفرق فيه بين الحلال والحرام، وكرَّر في المواعظ والقصص للأفهام، وضرب فيه الأمثال، وقصَّ فيه غيب الأخبار، فقال تعالى: ﴿ ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:38]”[9].
فالقرآن الكريم هو دستور المجتمع الإسلامي، وقد أحاط بكل صغيرة وكبيرة، وجاء للإنسانية بكل ما فيه خيرها وسعادتها، وكان ما شرعه لها مُحْكَمًا وعامًّا حتى يكون صالحًا لكل زمان ومكان[10].
وقد أنزل الله القرآن ليضبط بهدايته مسيرة الحياة والإنسانية، فهو كتاب الله الذي: ﴿ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:9]؛ أي: يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أفضل وأحسن وأصوب من غيرها من الطرق.
وهو أيضًا الكتاب الذي: ﴿ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت:42].
فهو خير للبشرية من كل نواحيها: الروحية، والعقلية، والاجتماعية، والعلمية، والفكرية، والاقتصادية، والثقافية، والعسكرية، وفي تعاليمه سعادة البشر.
فقد تضمن القرآن الكريم القواعد الكلية والأحكام المختلفة التي تُنظِّم علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته بربه، وعلاقته بمجتمعه وبأخيه الإنسان، فدعا إلى التوحيد، وإلى الحرية والإخاء والمساواة، كما نَظَّم المعاملات، ونَظَّم المجتمع على أُسُس سليمة تضمن له الأمن والرخاء والسعادة.
ثم إن الله عز وجل جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملًا، وتفسير ما كان منه مُشكلًا، وتحقيق ما كان منه محتملًا، ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به، ومنزلة التفويض إليه؛ قال تعالى: ﴿ وأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل:44]، فصار الكتاب أصلًا والسُّنَّة له بيانًا[11].
وهنا يأتي الأصل والأساس الثاني من أسس وأصول الإسلام، وهو السُّنَّة النبوية الشريفة، المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم، ففي المنهج النبوي المُفصَّل في تعليم الإسلام وتطبيقه وتربية الأمة عليه، والذي يتجسد في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران:164]، ويتمثل ذلك في أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته[12].
وقد قال الله تعالى يخاطب المؤمنين: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر:7].
فالسُّنَّة مُكَمِّلَة للقرآن ومُفَسِّرَة له، وقد روى عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: “دعونا من هذا وجيؤونا بكتاب الله”، فقال عمران: “إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مُفَسَّرة؟ أتجد في كتاب الله الزكاة مُفَسَّرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسُّنَّة تُفَسِّره”[13].
هذا، وقد أوجد هذان المصدران المستمدَّان من وحي السماء مجتمعًا مثاليًا فاضلًا، لم تر الإنسانية له مثيلًا، ومن ينظر في حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعد الإسلام، ويوازن بين الحالين، يُدْرِكُ في سهولة ويُسر أن الدِّينَ الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم هو الشيء الوحيد الجديد الذي جدَّ عليهم، وأنه هو الذي قوَّم أخلاقهم، وهذَّب نفوسهم، ووحَّد كلمتهم، وأصلح مجتمعهم، وأعلى شأنهم، وأعزَّ جانبهم، فأصبحوا بهذا الدين أمة عالمة بعد جاهلة، ورشيدة بعد غاوية، ونابهة بعد خمالة”[14].
[1] أبو المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي: كتاب الأصنام صـ 44.
[2] الرحيق المختوم لصفي الدين المباركفوري صـ 47
[3] قتادة السدوسي (60 – 117هـ): من كبار التابعين، وكان عالمًا بالحديث والنسب والشعر توفي بواسط، انظر تذكرة الحفاظ 1 /122.
[4] انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري (10 / 573).
[5] القافه: جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (انظر فتح الباري: 9/185).
[6] فالتاط: أي استلحقه به وأصل اللِّوط اللصوق (المصدر السابق).
[7] المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية للشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم ص 57.
[8] ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 91.
[9] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/11.
[10] تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي لأبي زيد شلبي ص 37.
[11] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/2.
[12] مدخل لمعرفة الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي.
[13] مفتاح الجنة للسيوطي صــ 59.
[14] تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي لأبي زيد شلبي صـ 61.
تمت قراءة هذا المقال بالفعل131 مرة!
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.