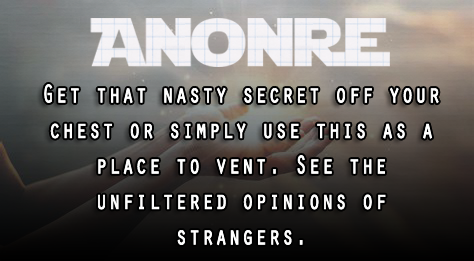أفي المال حقٌّ سوى الزكاة؟!
الزكاة هي الحق الواجب في المال، متى قامت بحاجة الفقراء، وسدَّت خلة المعوزين البائسين، وأطعمتهم من جوع، وأمَّنتهم من خوف، أما إذا لم تكفِ الزكاة، ولم تفِ بحاجة المحتاجين، وَجَبَ في المال حقٌّ آخر سوى الزكاة، وهذا الحق لا يتقيَّد ولا يتحدد إلا بالكفاية، فيُؤخذ من مال الأغنياء القدرَ الذي يقوم بكفاية الفقراء؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ تم تلا هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177]))؛ [أخرجه ابن ماجه في سننه، والترمذي في جامعه]؛ قال القرطبي: استدلَّ من قال: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، بقوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة: 177]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 177]، مما يدل على أن المراد بقوله: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة: 177] ليس الزكاة المفروضة، واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها؛ قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسْرَاهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع قال الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة: 177] هذا الإيتاء غير إيتاء الزكاة، وهو ركن من أركان البر، وواجب كالزكاة، وذلك حيث تعرِضُ الحاجة إلى البذل، في غير وقت أداء الزكاة، وهو لا يشترط فيه نصاب معين، بل هو على حسب الاستطاعة، فهذا البذل من غير مال الزكاة لا يتقيَّد بزمن، ولا بامتلاك نصابٍ محدود، ولا يكون المبذول مقدارًا معينًا بالنسبة إلى ما يملك ككونه عشرًا، أو ربعَ عُشر، أو عشر العشر مثلًا، وإنما هو أمر مُطلَق بالإحسان، موكول إلى أريحية المعطِي وحالة المعطَى؛ قال ابن حزم: وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد، أن يقوموا بفقرائهم، ويُجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تَقُم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين ما يقوم بهم، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف، والشمس، وعيون المارة؛ برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: 26]، وقوله تعالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 36]، فأوجَبَ تعالى حقَّ المسكين وابن السبيل وما ملكت اليمين من حقِّ ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى، والمساكين والجار، وما ملكت اليمين، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعُه إساءةٌ بلا شكٍّ؛ قال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ [المدثر: 42 – 44]، فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة؛ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله))، ومن كان على فَضْلَةٍ – أي زيادة عن الحاجة – ورأى المسلم أخاه جائعًا عريانًا ضائعًا فلم يُغِثْه، فما رحِمَه بلا شك، وعن عثمان النهدي: أن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق حدَّثه: أن أصحاب الصُّفَّة كانوا ناسًا فقراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان عنده طعام اثنين، فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة، فليذهب بخامس أو سادس))، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلِمه))، ومن تركه يجوع ويعرى، وهو قادر على إطعامه وكسوته، فقد أسلمه؛ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان معه فضلُ ظهرٍ، فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد، فليعُد به على من زاد له))، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حقَّ لأحد منا في فضل، وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أطعموا الجائع، وعُودُوا المريض، وفُكُّوا العاني))؛ أي الأسير، والنصوص من القرآن الكريم، والأحاديث الصحاح في هذا كثيرة جدًّا؛ وقال عمر رضي الله عنه: “لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأخذتُ فضول أموال الأغنياء، فقسمتها على فقراء المهاجرين”، وقال علي رضي الله عنه: “إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا، أو عَرُوا، وجهدوا، فبمنع الأغنياء، وحقٌّ على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذبهم عليه”، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “في مالِكَ حقٌّ سوى الزكاة”، وصحَّ عن أبي عبيدة بن الخراج وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فنِيَ، فأمرهم أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم منهم، وصحَّ عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة، ثم قال: ولا يحل لمسلم اضطُرَّ أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعامًا، فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذميٍّ؛ لأنه يجب فرضًا على صاحب الطعام إطعامُ الجائع، فإذا كان ذلك كذلك، فليس بمضطر إلى الميتة، ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل على ذلك، فإن قُتِل، فعلى قاتله القَود – أي يُقتل به – وإن قُتِلَ المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقًّا، وهو من الطائفة الباغية؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9]، ومانع الحق باغٍ على أخيه الذي له الحق، وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة[1]، واستدلوا بما جاءت به الأحاديث الصحاح، من حقوق الإبل والخيل؛ منها ما رواه النسائي، عن جابر بن عبدالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا وقف لها يوم القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ – أرض مستوية ملساء – تَطَؤُه ذاتُ الأظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقرونها، وليس فيها يومئذٍ جمَّاء – لا قرن لها – ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله، وماذا حقها؟ قال: إطراقُ فَحْلِها، وإعارة دلوِها، وحملٌ عليها في سبيل الله))، ومعنى إطراق فحلها: إعارته للضِّراب لا يمنعه ممن طلبه، وإعارة دلوها لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه، والحمل عليها في سبيل الله إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين، ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد: أنها رتَّبت الوعيد على منع الحقوق المذكورة، فدلَّت على أنها حقوق واجبة، وهي حقوق أخرى غير الزكاة، واستدلوا أيضًا بما صحت به الأحاديث من إيجاب حق الضيف على الْمَضِيف؛ منها عن أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرم ضيفَه جائزتَه يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة))؛ [رواه مالك والبخاري، ومسلم وأبو داود، والترمذي وابن ماجه]، والأمر بإكرامه يدل على الوجوب بدليل تعليق الإيمان عليه، وبدليل جعل ما بعد الثلاثة الأيام صدقة؛ ومن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما ضيفٍ نَزَلَ بقومٍ فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قِراه، ولا حرج عليه))؛ [رواه أحمد، ورواته ثقات، والحاكم]، وروى المقدام بن معديكرب الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا، فإنَّ نصره حقٌّ على كل مسلم حتى يأخذ بقِرى ليلته من زرعه وماله))؛ [رواه أبو داود والحاكم]، واستدلوا أيضًا بما جاء في القرآن الكريم من الوعيد بشأن الذين يمنعون الماعون؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: 5 – 7]، وقد روى أبو داود عن عبدالله بن مسعود قال: “كنا نعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاريةَ الدلو والقِدر”، ومعنى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة التي يحتاج إليها بعض الجيران من بعض واجبة؛ لأن مانعها مذموم مستحق للويل؛ كالساهي عن الصلاة المرائي، ولا يستحق المكلَّف الويل إلا على ترك واجب، وإذا ثبت أن إعارة هذه الأشياء واجبة وهي غير الزكاة قطعًا، فقد ثبت أن في المال حقًّا سوى الزكاة، وعن ابن عمر: الماعون هو المال يُمنَع حقه؛ قال ابن حزم: وهو موافق لِما ذكرناه؛ وهو قول عكرمة وإبراهيم وغيرهما، وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافًا لهذا، واستدلوا أيضًا بالآيات التي أوجبت التعاون والتكافل والتراحم بين المسلمين، وفرضت إطعام المسكين والحض عليه، وجعلت ذلك من ثمرات الأُخوة، ومقتضيات الإيمان والإسلام؛ من ذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، وقوله تعالى في وصف المؤمنين كما جاء في آخر سورة الفتح: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: 29]، وبين العقبة التي على كل إنسان أن يجتازها لينال مثوبة الله، ويكون من أصحاب الميمنة؛ فقال تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [البلد: 11 – 18]، فطبيعة النظام الإسلامي كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية، وأحاديث الرسول صحاحًا وحِسانًا، تجعل التكافل في المجتمع فريضة لازمة، والتعاون والمواساة واجبًا لا بد من أدائه، فالقويُّ فيه يحمل الضعيف، والغنيُّ يأخذ بيد الفقير، والقريب يصل قرابته، والجار يُحسن إلى جاره، ومن أضاع هذه التعاليم، فليس من الإسلام ولا من رسوله في شيء، وبريء من الله، والله بريء منه.
إن الذي يتضح مما سبق أن الزكاة هي الحق الدوريُّ المحدَّد الثابت في المال، والواجب على الأعيان بصفة دائمة؛ شكرًا لنعمة الله، وتطهيرًا وتزكية للنفس والمال، وهو حق واجب الأداء، ولو لم يجد فقيرًا يستحق المواساة، أو حاجة تستدعي المساهمة، فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يُطالَب بشيء في ماله غير الزكاة، فإذا أدَّاها فقد قضى ما عليه، وأذهب عن نفسه شر ماله، وليس عليه شيء آخر، إلا أن يطَّوَّع، أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة، وغير مقدَّرة بمقدار معلوم، كمقادير الزكاة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات، وتتغير بتغير العصور والبيئات، وهي في الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين، وقد تتعين أحيانًا؛ كأن يرى الشخص مضطرًّا وهو قادر على دفع ضرورته، فيجب عليه دفعها، أو يكون له جار جائع، أو عريان، وهو قادر على معونته، كما أن الغالب أنْ تُوكِلَ هذه الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السلطة، إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة القانون فرضًا ما أوجبه الإيمان إيجابًا، وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد، واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها، كما في عصرنا الحديث، فحينئذٍ لا بد من تدخل الدولة وإلزامها.
وإذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حقًّا معلومًا في أموال المسلمين، وجعلها ضريبةً تتولَّاها الحكومة المسلمة جباية وصرفًا، فهل يجوز لهذه الحكومة أن تفرِض على الأغنياء ضرائبَ أخرى إلى جوار الزكاة؛ لإقامة مصالح الأمة، وتغطية النفقات العامة للدولة، أم تعد الزكاة هي الفريضة المالية الوحيدة التي لا يُؤخذ من المسلمين غيرها؟ لكي يتضح هذا الأمر جليًّا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، نجعل الكلام فيه حول مباحث ثلاثة؛ هي: الأدلة على جواز فرض الضرائب، والشروط التي يجب مراعاتها في فرض الضرائب، وشُبُهات المانعين لفرض الضرائب والرد عليها، أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة؛ فهي: أن التضامن الاجتماعي فريضة، وحسبنا أن نذكر أن الجميع متَّفقون على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة عامة بعد الزكاة، وجَبَ سدُّها، مهما استغرق ذلك من الأموال، إن مصارف الزكاة محدودة، ونفقات الدولة كثيرة، فمصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ولم يُجِزِ الفقهاء أن يُخلَط مالها بأموال الموارد الأخرى، لتصرف في مصارفها الشرعية المنصوص عليها؛ ومن أجل ذلك قال أبو يوسف: “لا ينبغي أن يُضمَّ مال الخراج إلى مال الصدقات؛ لأن الخراج فَيءٌ لجميع المسلمين، والصدقات لمن سمَّى الله عز وجل”، ولهذا أيضًا قالوا: لا تُصرَف الزكاة إلى بناء الجسور، وتمهيد الطرق، وشق الأنهار، وبناء المساجد والرُّبط والمدارس والسقايات، وسد البثوق، ولكن هذه الأمور ضرورية للدولة الإسلامية ولأي دولة، فمن أين تُنفِق على هذه المرافق، إذا لم يَجُز له الصرف من الزكاة؟ والجواب: أنها كانت تُنفِق على هذه المصالح من خمس الغنائم الحربية التي يستولي عليها المسلمون من أعدائهم المحاربين، أو مما أفاء الله عليهم من أموال المشركين بغير حربٍ ولا قتال، وكان هذان الموردان في عهود الفتح الإسلامي الأولى يُغنيان الخزانة بما لا تحتاج معه إلى فرض ضرائب على الناس غير الزكاة، أما في عصرنا وقد نَضَبَ هذان الموردان، فلم يعُد لإقامة مصالح الأمة موردٌ إلا فرض ضرائب أو وظائف على ذوي المال، بقدر ما يحقق المصلحة الواجب تحقيقها، وفقًا لقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ووفقًا لعدة قواعد كلية ومبادئ تشريعية عامة، أصَّلها علماء الإسلام، من هذه القواعد رعاية المصالح، ودرء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلًا لأعلاهما، ويُتحمَّل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ولا ريب أن تحكُّم هذه القواعد الشرعية لا يؤدي إلى إباحة الضرائب فحسب، بل يحتم فرضها وأخذها، تحقيقًا لمصالح الأمة والدولة، ودرءًا للمفاسد والأضرار والأخطار عنها، ما لم تكن عندها موارد أخرى كافية؛ ولهذا أفتى علماء المسلمين في عصور مختلفة بوجوب إمداد بيت المال بما يلزمه من ضرائب، يفرِضها الحاكم المسلم لدرءِ خطرٍ أو سدِّ حاجة؛ يقول أبو حامد الغزالي: “وإذا خَلَتِ الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بجراحات العسكر، وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام، أو ثوران الفتنة من قِبَلِ أهل الشر، جاز للإمام أن يوظِّف على الأغنياء مقدار كفاية الجند؛ لأنَّا نعلم أنه إذا تعارض شرَّان أو ضرران، قصد الشرع دفع أشد الضررين، وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم – أي من الأغنياء – قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله، لو خلت خطة الإسلام – أي بلاده – من ذي شوكة – أي حاكم قوي – يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور”، وقال الشاطبي المالكي: “أنا إذا قدرنا إمامًا مُطاعًا مُفتقرًا إلى تكثير الجنود لسدِّ حاجة الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجة الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلًا أن يوظِّف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه – أي إلى الأمام – النظر في توظيف ذلك على الغلَّات والثمار وغير ذلك”، كما أن الإسلام قد فرض على المسلمين الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في مثل قوله تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 41]، ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: 15]، ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195]، ولا شكَّ أن الجهاد بالمال المأمور به واجب آخرُ غيرُ فريضة الزكاة، ومن حق أُولي الأمر في المسلمين أن يحددوا نصيب كل فرد قادر من عبء الجهاد بالمال، كما أن الأموال التي تُجبى من الضرائب تُنفَق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة؛ كالدفاع والأمن والقضاء، والتعليم والصحة، والنقل والمواصلات، والري والصرف، وغيرهم من المصالح التي يستفيد منها مجموع المسلمين، من قريب أو من بعيد، وإذا كان الفرد يستفيد من وجود الدولة وسيطرتها، ويتمتع بالمرافق العامة في ظل إشرافها وتنظيمها وحمايتها للأمن الداخلي والخارجي، فعليه أن يُمِدَّها بالمال اللازم لتقوم بمسؤوليتها، وكما يستفيد الفرد ويغنم من المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة، ففي مقابل هذا يجب أن يغرم ويدفع ما يخصه من ضرائب والتزامات، تطبيقًا للمبدأ الذي قرره الفقهاء وهو الغُرم بالغُنم، ولكن الضريبة التي يعترف لها الإسلام بالشرعية، ويرضى نظامه عنها هي التي تتوافر لها الشروط الآتية: الحاجة الحقيقية إلى المال ولا مورد آخر، وإذا تحققت الحاجة إلى المال، ولم يوجد مورد لسدِّ هذه الحاجة إلا بالضرائب، لم يكن فرضها جائزًا فحسب بل واجبًا، بشرط أن توزَّع أعباء الضريبة على الناس بالعدل، بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تُحابَى طائفة، ويُضاعَف الواجب على طائفة أخرى، بغير مسوِّغ يقتضي ذلك، ولا يكفي أن تُؤخذ الضريبة بالحق، وتُوزَّع أعباؤها على الناس بالعدل، ما لم يتم صرفها في المصالح العامة للأمة، لا في شهوات الحكَّام وأغراضهم الشخصية، وفي ترفِ أُسَرِهم وخاصَّتهم، وفي رغبات أتباعهم والسائرين في ركابهم، ولا يجوز أن ينفرد الإمام أو رئيس الدولة الأعلى فضلًا عن نوَّابه وولاته في الأقاليم بفرض هذه الضرائب، وتحديد مقاديرها، وأخذها من الناس، بل لا بد أن يتم ذلك بموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعَقْدِ في الأمة.
ويُثار تساؤل: ما حكم التهرُّب من الضريبة في ميزان الإسلام؟ لقد تناول فقهاء الإسلام المعاصرون هذه القضية بشيء من التفصيل، وخلصوا إلى مجموعة من القرارات والفتاوى؛ من أهمها ما يلي: يجوز لولي الأمر أن يوظِّف على أموال الأغنياء ضرائبَ بضوابط شرعية للإنفاق منها على الخدمات العامة، التي لا تدخل في نطاق مصارف الزكاة؛ مثل: الأمن والتعليم، والعلاج والمرافق، التي تعتبر من الضروريات للناس، وتأسيسًا على ذلك لا يجوز التهرب من أدائها، يجب أن تُفرَض الضرائب بالحق، وتُحصَّل بالحق، وتُنفَق في الحق، وإذا تحققت هذه الشروط الثلاث، أصبحت الضريبة عادلة وواجبة الأداء، وأيضًا تجنب فرض الضرائب الظالمة لأنها من المكوس التي حرمتها الشريعة الإسلامية.
وخلاصة الرأي: أنه لا يجوز التهرُّب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وما في حكم ذلك؛ باعتبارها من الموارد السياسية للدولة، وإن كان هناك من ظلم فيُزال بالأساليب المعتبرة شرعًا وقانونًا، ويعتبر ولي الأمر مسؤولًا عن أي مخالفات شرعية، ولا يجوز تعطيل فرضية الزكاة بدعوى تطبيق الضرائب[2].
تمت قراءة هذا المقال بالفعل5 مرة!
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.