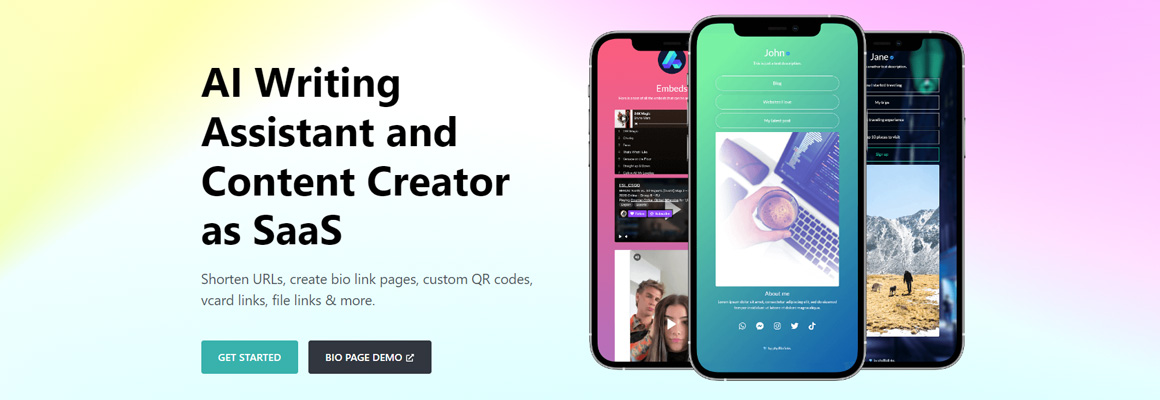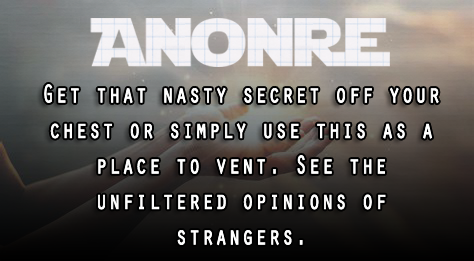﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾
قال تعالى: ﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران: 72 – 74].
لما ذكر الله تعالى مكرَهم بالقول في الآية السابقة: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 71]، ذكر مكرهم بالحيل الفعلية، وقيل: الطائفة الأولى حاولت الإضلال بالمجاهرة، وهذه الطائفة حاولته بالمخادعة:
﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا ﴾: أظْهِرُوا الإيمان، ولا يمكن أن يُراد به التصديق.
﴿ بِالَّذِي أُنْزِلَ ﴾ يعني: القرآن، وإن شئتَ فَقُل: الشريعة كلها.
﴿ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾؛ أي: على زعمهم، وإلا فهم يكذبون، ولا يصدقون أن الله أنزل شيئًا على المؤمنين؛ أي إن اليهود أطلقوا هذه الصلة على أتباع محمد إذ صارت عَلَمًا بالغلبة عليهم.
﴿ وَجْهَ النَّهَارِ ﴾ أوله وهو الصباح، شُبِّهَ بوجه الإنسان إذ هو أول ما يواجَهُ منه.
والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: ﴿ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ﴾، وهذه إحدى الطرق التي يُعلَم بها معنى الكلمات في القرآن الكريم؛ أن يُعلَم معنى الكلمة بذكر مقابلها؛ كقوله تعالى: ﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: 71] ثُباتٍ: يعني: وحدانًا متفرقين.
﴿ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ﴾: واجحدوا به مساءً، مُرائين لهم أنكم آمنتم به بادِيَ الرأي من غير تأملٍ، ثم تأملتم فيه، فوقَفتُم على خلل رأيِكم الأولِ فرجعتم عنه، والغرض هو بَلْبَلَةُ أفكار المسلمين وإدخال الشك عليهم.
واختيار وجه النهار؛ لأنه وقت اجتماعهم بالمؤمنين يراؤونهم، وآخره لأنه وقت خلوتهم بأمثالهم من الكفار.
﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي: المؤمنين ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: 72] عن دينهم.
فهذه مكيدة أرادوها ليلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمْرَ دينهم؛ وهو أنهم اشْتَوروا بينهم أن يُظْهِروا الإيمان أول النهار، ويُصَلُّوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار، ارتدُّوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدَّهم إلى دينهم اطِّلاعُهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين؛ لأنهم أهل كتاب، ولولا أنهم علِموا أن هذا دين باطل، لم يرجعوا.
ولذلك سأل هرقل أبا سفيان حينما لاقاه في الشام عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: ((هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ))؛ [البخاري].
وقيل: أُشير إلى طائفة من اليهود، منهم كعبُ بنُ الأشرفِ، ومالكُ بنُ الصيفِ، وغيرهما من يهود خيبر، أغواهم العجب بدينهم، فتوهَّموا أنهم قدوة للناس، فلما أعيَتْهم المجاهرة بالمكابرة، دبَّروا للكيد مكيدة أخرى، فقالوا لطائفة من أتباعهم: آمنوا بمحمد أول النهار مُظْهِرين أنكم صدقتموه، ثم اكفروا آخر النهار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجرِبة، فيقول المسلمون: ما صرف هؤلاء عنا إلا ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذا الدين، وأنه ليس هو الدين الْمُبَشَّرَ به في الكتب السَّالِفَةِ، ففعلوا ذلك.
وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن أن يفسَّر بآية سورة البقرة: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: 109].
• وفيه التوبيخ لمن سلك هذا المسلك، ووجه ذلك: أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصًا للشخص والعين، ولكنه بالجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم، فإنه يستحق هذا التوبيخ.
﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا ﴾ لا تصدقوا ﴿ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ من أهل ملَّتِكم، وهذا صَرْفٌ من رؤسائهم للأتباع عن الإسلام وقبوله؛ أي: لا تصدقوا المسلمين فيما يقولون لكم.
أو لا تطْمَئِنُّوا وتُظهِروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، كأنهم يقولون: اخفوا هذه الطريقة إلا على من تَبِع دينكم، فمن تبع دينكم، أخْبِرُوه، أما غيرهم فلا تخبروهم.
﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ﴾ من كلام الله تعالى مخاطبًا لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ أي هو تعالى الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان، ويُثبِّتهم عليه، بما ينزله على عبده ورسوله محمدٍ صلى الله عليه وسلم من الآيات البيِّنات، والدلائل القاطعات، والحُجَجِ الواضحات.
وهذه الجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها، لكنها في محل موافق تمامًا، ومفيدٌ لكون كيدِهم غيرَ مُجدٍ لطائل، ومعنى الاعتراض أنه أخبر تعالى بأن ما راموا من الكيد والخداع بقولهم: ﴿ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران: 72]؛ الآية، لا يُجدي شيئًا، ولا يصدُّ عن الإيمان من أراد الله إيمانه؛ لأن الهدى هو هدى الله، فليس لأحدٍ أن يحصله لأحد، ولا أن ينفيه عن أحد، وفي هذا الجواب إظهار الاستغناء عن متابعتهم.
﴿ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ كلام متصل بقول الطائفة، ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾، والمعنى: قلتم ذلك القول، ودبَّرتم تلك المكيدة؛ حسدًا وخوفًا من أن تذهب رئاستكم، ويشارككم أحد فيما أُوتيتم من فضل العلم، فلا تُظهِروا ما بأيديكم من العلم للمسلمين، فيتعلموا منكم فيساووكم في العلم به، وتكونَ لهم الأفضلية عليكم، ويمتازوا به عليكم؛ لشدة الإيمان به.
فتقدير الكلام: لئلا يُؤتَى أحد مثل ما أوتيتم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ [النساء: 176]؛ أي: لئلا تضلوا.
• وفيه: أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بيَّنوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ [آل عمران: 73]؛ لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسدُ؛ قال تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: 109]، ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: 54].
﴿ أَوْ ﴾ حرف «أو» للتقسيم؛ مثل: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 24]، ﴿ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ﴾؛ أي: يتخذوا العلم مما بأيديكم حُجَّة عليكم، فتقوم به عليكم الدلالة، وتَتَركَّب الحُجَّةُ، فيغلبوكم ويدحضوا حجتكم عند الله في الدنيا والآخرة.
وقيل: يخاصموكم يوم القيامة عند ربكم، وتكون لهم الحجة عليكم إن أنتم اعترفتم لهم اليوم بأن نبيهم حق ودينهم حق؛ فلذا واصِلُوا الإصرار أنه لا دين حق إلا اليهودية، وأن ما عداها باطل، فقالوا ذلك حسدًا؛ حيث كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم من غيرهم، وهذا القول – على هذا المعنى – ثمرة الحسد والكفر مع المعرفة بصحة نبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول معطوف على قولهم: ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ [آل عمران: 73].
كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: 17]، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر: 31].
﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ ﴾ هو النبوة والهدى والتوفيق للإيمان، والهداية للإسلام، وما يتبع ذلك من خير الدنيا والآخرة.
﴿ بِيَدِ اللَّهِ ﴾ بيد الله لا بيد غيره، أي: متصرِّف فيه كالشيء في اليد، وهذه كناية عن قدرة التصرُّف والتمكن فيها.
أي: الأمورُ كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يَمُنُّ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء، ويُعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحُجَّة والحكمة.
والآية توكيد لمعنى: ﴿ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 73]، وفي ذلك تكذيب لليهود؛ حيث قالوا: شريعة موسى مؤبَّدة، ولن يؤتي الله أحدًا مثل ما أُوتي بنو إسرائيل من النبوة، فالفضل هو بيد الله.
﴿ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ من عباده، ويحرمه من يشاء.
• وفيه إثبات المشيئة لله تعالى، ولا أحد ينكر إثبات مشيئة الله، فما يتعلق بفعله تابع لمشيئته، ولا يكون إلا بمشيئته، ولكن اختلفت الأمة في فعل العبد: هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟
فأهل السنة والجماعة قالوا: إنه يكون بمشيئة الله، مع إثبات إرادة العبد؛ أي: فعل العبد بمشيئة الله، مع إثبات إرادة العبد له.
وذهبت القدرية – مجوس هذه الأمة – إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حرٌّ يفعل ما يشاء، ولا تعلُّق لإرادة الله ومشيئته بفعله، وبهذا سُمُّوا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقلٌّ بما يُحدثه، فجعلوا للحوادث خالقَينِ: الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضًا، فالله خالق لأفعاله، والإنسان خالق لأفعاله، والله شاء لأفعاله، والإنسان شاء لأفعاله، ولا تعلُّق لمشيئة الله بفعل العبد.
وهناك طائفة أخرى وهم الجبرية قابلتهم، فقالت: أفعال العبد بمشيئة الله، ولا إرادة للعبد فيها، إن قام فهو مُجبر، وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وإن تدحرج رغمًا عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر… كله إجبار ما له اختيار، وهؤلاء أيضًا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس، لو أن أحدًا منهم وقف أمامنا وقال: الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفًّا، وقال: أنا مجبر على أن أضربك كفًّا فلن يرضى؛ ولهذا يُذكَر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفِعَ إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال: مهلًا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله؛ يعني غصبًا، فقال: “ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله”، فردَّ عليه بحُجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله، وشرع الله.
ومشيئة الله مقيَّدة بالحكمة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: 30]، يدل على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئًا إلا لحكمة، ولكن الحكمة قد تَبِينُ لنا وقد تَخْفَى علينا؛ لأن عقولنا قاصرة، قد نظن – مثلًا – أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، وقد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر.
﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ ذو سعة بفضله؛ فهو سبحانه واسع في كل صفاته: واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة، في كل الصفات، وسَعَةُ صفاته تعالى أنها لا حدَّ لتعلُّقاتها، فهو أحق الموجودات بوصف واسع؛ لأنه الواسع المطلق.
قال ابن عاشور: وقد يُؤتَى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز؛ نحو: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: 98]، ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: 7]، فوصفه في هذه الآية بأنه واسع هو سعة الفضل؛ لأنه وقع تذييلًا لقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: 73]، وأحسَبُ أن وصف الله بصفة واسع في العربية من مبتكرات القرآن.
﴿ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 73] بمن يستحق فضله فيمُنُّ عليه، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة.
والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركَّب، وهو أشدهما عمًى؛ لأنه جاهل وهو جاهل أنه جاهل؛ ولهذا قيل: إن الجهل المركب أشد قبحًا من الجهل البسيط، فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثمًا من الجاهل؛ لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علِمَ ولكنه – والعياذ بالله – لم يعمل بعلمه.
إذًا الله تعالى عالم، مدرك للأشياء على ما هي عليه، وعلمه تعالى تام من كل وجه أزلًا وأبدًا، فلم يزل عالمًا يعلم ما سيكون، وإذا علِمَ وهو عالم عز وجل فلن ينسى؛ كما قال موسى عليه السلام: ﴿ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه: 52].
وقال أهل العلم: لا يُوصَف الله بأنه عارف؛ لأن المعرفة انكشاف بعد لَبْسٍ وخفاء؛ ولهذا إذا علمت الصبي تقول له: هل عرفت؟ فيقول: نعم؛ يعني بعد أن كان خافيًا عليه صار الآن معلومًا له، فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصحَّ إطلاقها على الله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال عالمًا.
ثانيًا: أن المعرفة تُطلَق على العلم والظن، ولهذا إذا قلنا: العلم معرفة الحق بدليله، شمل قولنا: (معرفة الحق بدليله) العلمَ والظنَّ؛ لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية، لهذا لا يصح أن يطلق على الله أنه عارف.
فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تَعرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ، يَعْرِفكَ في الشِّدَّةِ))؛ [المعجم الكبير]، (يعرفك) وهذا فعل.
فالجواب عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرف إلى الله من قبل، والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي «معرفة العناية» قوله: (تعرَّف إلى الله)، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقُم، لكن إذا قمت بعبادته تعرَّفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء، عرَفك في الشدة.
﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ يختص بمعنى يخُصُّ بالرحمة من يشاء، ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: 124]، فكل فعل من أفعال الله قُرِن بالمشيئة فهو تابع للحكمة؛ فهو سبحانه عليم حكيم، يُؤتِي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل.
• وفيه أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدًا، ويمنع رحمته عن عمرو؛ لأن الأمر إليه، وهو فضلٌ، إن شاء منعه، وإن شاء أعطاه، ويتفرع على هذه الفائدة أن من مُنِعوا فضلَ الله لم يكونوا قد ظُلِموا شيئًا؛ لأن فضل الله يؤتيه من يشاء، ويختص برحمته من يشاء.
﴿ وَاللَّهُ ذُو ﴾ صاحب ﴿ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران: 74] الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضله، وانظر إلى ما أنعم الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص مما عند الله شيئًا.
وفي الحديث القدسي: ((يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ))؛ [مسلم].
• وفيه: جواز وصف غير الله بالعِظَمِ؛ لأن الفضل هنا يحتمل أن يُراد بها الفضل الذي هو فضل الله؛ أي عطاؤه، أو أن المراد بها المُتَفضَّل به، وهو المُعْطَى، فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يُوصَف به غير الله، وعلى الأول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس فعل الله، فوصفه بالعظم لا إشكال فيه؛ لأنه من صفات الله، وصفات الله كذاته عظيمة.
وهذا مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: 23]، فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق؛ إذًا يصح أن نقول: هذا الفعل عظيم، وهذا رجل عظيم، هذه سيارة عظيمة، هذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك، ولا يضر، كما أنه يصح أن نقول: فلان عزيز، فلان قوي، ولا حرج في ذلك، ولكن يجب أن نعلم أن ما نصف به المخلوق من صفات الله لا يماثل صفات الله، ولا يدانيها أيضًا؛ لأن الصفة تكون لموصوف تناسبه؛ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.