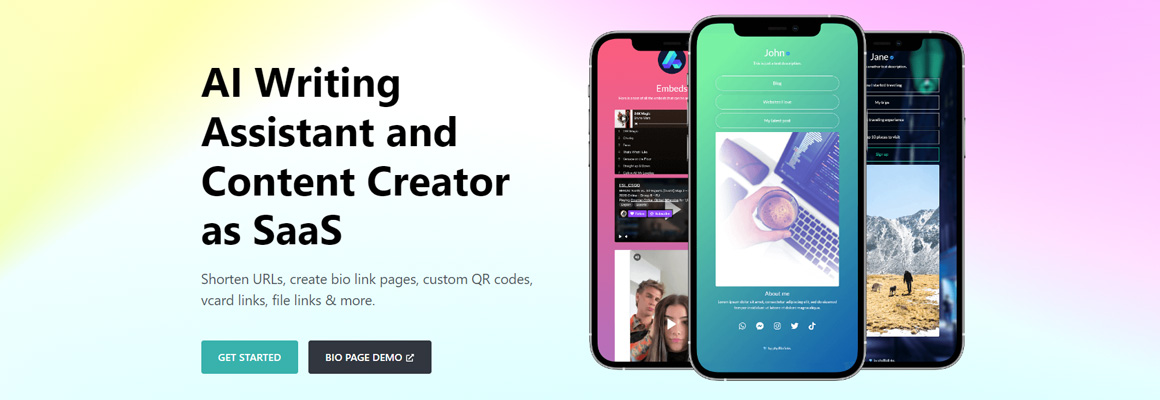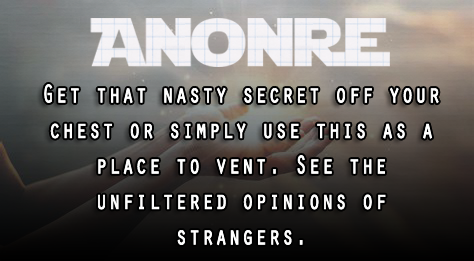﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾
﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 64 – 68].
﴿ قُلْ ﴾ [آل عمران: 64] يا محمد، والقاعدة أن الله تعالى إذا صدَّر الشيء بـ(قل) الموجَّه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقتضي زيادة العناية به؛ لأنه أمرٌ بأن يبلِّغ هذا الشيء بخصوصه، وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله.
﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: 64]؛ يعني بهم اليهود والنصارى، وإنما وُصِفوا بأهل الكتاب؛ لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها – وإن كان بها تحريف وتغيير – إلا التوراة والإنجيل، وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به؛ كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الحديد: 25].
وخاطبهم بـ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴾ [آل عمران: 64]؛ هزًّا لهم في استماع ما يُلقَى إليهم، وتنبيهًا على أن من كان أهلَ كتابٍ من الله، ينبغي أن يتبع كتابَ الله.
﴿ تَعَالَوْا ﴾ [آل عمران: 64]: ارتَفِعوا من وَهْدَةِ الباطل التي أنتم واقعون فيها.
﴿ إِلَى كَلِمَةٍ ﴾ [آل عمران: 64]، والكلمة هنا أُطْلِقت على الكلام الوجيز؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ [المؤمنون: 100]، وإما لكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض، فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا اختلَّ جزءٌ منها اختلَّتِ الكلمة.
﴿ سَوَاءٍ ﴾ [آل عمران: 64] كلمةِ عدلٍ وإنصاف، لا تختلف فيها الشرائع، نستوي نحن وإياكم فيها، واتفقت عليها جميع الرسل والكتب التي أُنزلت إليهم.
ولمَّا قطعهم بالدلائل الواضحة فلم يُذْعنوا، ودعاهم إلى المباهلة فامتنعوا، عَدَلَ إلى نوع من التلطُّف؛ وهو: دعاؤهم إلى كلمة فيها إنصاف بينهم؛ قال ابن زيد: “لما أبى أهل نجران ما دُعُوا إليه من الملاعنة، دُعُوا إلى أيسر من ذلك؛ وهي الكلمة السواء”.
﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: 64]، ثم فسَّر الكلمة بقوله: ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [آل عمران: 64]؛ أي: لا نخضع ولا نذِلَّ الذُّلَّ المطلق والخضوع المطلق إلا لله وحده عز وجل؛ لأن العبادة يُراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق، ويُراد بها المتعبَّد به؛ أي العبادات التي يقوم بها العبد، فهي تشمل هذين المعنَيَين.
ومن مقتضيات العبودية الإقرارُ بأن له تعالى وحده السلطة المطلقة في التدبير والتشريع، والتحريم والتحليل.
﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: 64] توكيدًا للتوحيد؛ أي: ولا نجعل غيره شريكًا له في استحقاق العبادة من الشُّرَكاء والوُسَطاء والأرباب الذين يُحلِّلون ويُحرِّمون، وهذه دعوة جميع الرسل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 25]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36].
﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ﴾ [آل عمران: 64] جمع ربٍّ؛ وهو المألوه المطاع، وفيه إشارة لطيفة؛ وهي أن البعضِيَّة تنافي الإلهية؛ إذ هي تماثُلٌ في البشرية، وما كان مثلك استحال أن يكون إلهًا، وإذا كانوا قد استبعدوا اتباع من شاركهم في البشرية للاختصاص بالنبوة؛ في قولهم: ﴿ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ [إبراهيم: 10]، ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [إبراهيم: 11]، ﴿ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ [المؤمنون: 47]، فادعاء الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشد استبعادًا.
﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64] لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه، إلا فيما حلَّله الله تعالى؛ وهو نظير قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 31]، معناه أنهم أنزلوهم منزلةَ ربِّهم، في قبول تحريمهم وتحليلهم لِما لَمْ يحرمه الله تعالى ولم يُحلَّه، وهذا يدل على بطلان القول بالاستحسان المجرد، الذي لا يستند إلى دليل شرعي.
• وفيه أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان؛ لأن الله قرن بينهما، ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64]؛ لأنك لن تعبد الله إلا بشريعته، إذًا يلزم أن يكون المشرِّع هو المعبود.
• وفيه أنه لا يُصلِح حال البشرية ولا يستقيم أمرها، إلا إذا أخذت بمبدأ: «الكلمة السواء»؛ وهي: أن تعبد ربها وحده لا تشرك به سواه، وألَّا يعلوَ بعضها على بعض تحت أي قانون أو شعار.
• وفيه أن من دعا الناس إلى حلٍّ أو حرام، لكن بإذن الله وشرعه، فهو على حقٍّ تُؤخَذ من قوله: ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64]، فهو سبحانه وتعالى لم يَقُلْ: ﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ﴾ [آل عمران: 64] فحسب، بل قال: ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64].
﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ [آل عمران: 64]: أعرضوا عن هذا النَّصَف، وهذه الدعوة إلى التوحيد.
﴿ فَقُولُوا اشْهَدُوا ﴾ [آل عمران: 64]: اعلموا عِلْمَ رؤية ومشاهدة، وعبَّر عن العلم بالشهادة على سبيل المبالغة؛ إذ خرج ذلك من حيز المعقول إلى حيز المشهود، وهو المحضر في الحسِّ.
﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64] منقادون إليها، وهذا مبالغة في المباينة لهم؛ أي: إذا كنتم متولِّين عن هذه الكلمة، فإنا قابلون لها ومطيعون، وفي هذا تعريض بل تصريح بأن غيرهم ليسوا مسلمين.
• وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يعتزَّ بدينه، وأن يعلنه، ويُشهِرَه، خلافًا للضعفاء الذين عندهم هزيمة نفسية، وقلة دين، الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يُعيَّروا به.
وهذه الآية كانت في الكتاب الذي وجَّه به رسول الله صلى الله عليه وسلم دِحْيَةَ إلى عظيم بُصرى، فدفعه إلى هِرقْلَ.
روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصرَ، وكان قيصرُ لما كشف الله عنه جنود فارسَ، مشى من حمص إلى إيلياء؛ شكرًا لِما أبلاه الله، فلما جاء قيصرَ كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحدًا من قومه؛ لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال:
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدِالله ورسوله إلى هرقل عظيمِ الروم، سلامٌ على من اتبع الهدى؛ أما بعد: فإني أدعوك بدِعاية الإسلام، أسْلِمْ تَسْلَمْ، وأسْلِمْ يؤتِك الله أجرك مرتين، فإن توليتَ، فعليك إثم الأَرِيسِيِّين – هم الأكَّارون أي: الفلاحون والزراعون، والمعنى: أن عليه إثم رعاياه الذي يتبعونه وينقادون بانقياده – و﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 64])).
﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ ﴾ [آل عمران: 65] استفهام للإنكار والتوبيخ، ﴿ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران: 65] في شأنه وحاله، فتدَّعي كل طائفة منكم أن إبراهيم كان على دينها، أو تقول إنها على دين إبراهيم، وفيه إشارة إلى علو شأن إبراهيم عليه السلام، ومنزلته بين جميع الطوائف.
﴿ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [آل عمران: 65]؛ لأن التوراة والإنجيل لم يَرِدْ فيهما التصريح بأنهم دين إبراهيم، وأن موسى وعيسى عليهما السلام لم يخبرا بأنهما على الحنيفية، وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم، وانتساب اليهودية والنصرانية إليه، فلا يقولون: وكيف يُدَّعى أن الإسلام دين إبراهيم، مع أن القرآن أُنزل من بعد إبراهيم، كما أُنزلت التوراة والإنجيل من بعده؟
قال تعالى: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 132].
﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: 135، 136].
﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68]، ويُقال: كان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين، وفيه حجية التاريخ وبيان الحاجة إليه.
وبُنِيَ الفعل للمجهول للعلم بالمنزل؛ وهو الله عز وجل، والقرآن يفسر بعضه بعضًا، وفي هذه السورة نفسها، وفي أولها: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران: 3].
وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، فالخالق هو الله عز وجل لكن حُذِف للعلم به، ولكن لما كان الضعف صفةَ نقصٍ بُنِيَ الفعل هنا للمجهول، كما بُنِيَ للمجهول في قوله: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: 10]، فالشر لم يضيفوه إلى الله مباشرة تأدبًا، والرشد أضافوه إلى الله مباشرة.
﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 65]؛ أي: هذا كلام من لا يَعْقِل، إذ العقل يمنع من ذلك، توبيخ على استحالة مقالتهم، وتنبيه على ما يظهر به غلطهم ومكابرتهم.
والمراد بالعقل هنا «عقل الرشد»، وليس «عقل الإدراك»؛ لأن هؤلاء عندهم عقلُ إدراك، والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناطُ التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف، يعني: إن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، وعقل الإدراك يكون به توجيه التكليف إلى العقل؛ ولهذا يُقال للرجل العاقل الذكي إذا أساء في تصرفه، يُقال: هذا مجنون، هذا غير عاقل، مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقلٌ.
• وفيه بيان الاحتجاج بالعقل، وأنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وحده وترك النص.
فالحاصل أن في هذه الآية اعتبارَ العقل دليلًا، ولكن بشرط ألَّا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع، فالأصح أن نقول: إنه ليس بعقل؛ لأن «صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدًا»، لكن إذا ظُنَّ أن العقل يخالفه، فإما أن تكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غيرَ صحيح، ملوَّثًا بالشُّبهات والشهوات.
﴿ هَا ﴾ [آل عمران: 66] حرف تنبيه، نُبِّهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها، والتنبيه هنا حسن؛ وذلك لأنه يخاطب قومًا لمزَهم بعدم العقل، والذي ليس عنده عقل ينبغي أن يُصدَّر الخطاب له بما يقتضي تنبيهه؛ لأنه غافل، والغافل يتصرف تصرف مجنون، فاحتيج إلى أن يُنبَّه؛ فلذلك أتى بهاء التنبيه.
﴿ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ ﴾ [آل عمران: 66] عنادًا وضلالًا، ﴿ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: 66] على ما تزعمون من أمر عيسى، وقد قامت عليكم الحجة، وتبين أن منكم من غلا وأفرط وادعى ألوهيته، ومنكم من فرَّط وقال: إنه دَعِيٌّ كذَّاب، ولم يكن علمكم بمانع لكم من الخطأ.
﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: 66]، فلماذا تحاجون في أمر إبراهيم، وليس لكم به علم، ولا لدينه ذكرٌ في كتبكم، فمن أين أتاكم أنه كان يهوديًّا أو نصرانيًّا؟!
﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ [آل عمران: 66] ما حاجَجْتُم فيه، ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 66]؛ أي: والله يعلم ما غاب عنكم ولم تشاهدوه، ولم تأتِكم به الرسل من أمر إبراهيم وغيره، مما تجادلون فيه، وأنتم لا تعلمون إلا ما عاينتُم وشاهدتم وأدركتم علمه بالسماع، وهو تأكيد لما قبله من نفي العلم عنهم في شأن إبراهيم.
ونفيُ العلم عنهم هنا ليس رفعًا للإثم عنهم، ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم، وأن تصرفهم كتصرف الجاهل؛ فهو في الأول قال: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: 65]، وفي الثاني قال: ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 66]، فجمعوا بين السَّفَهِ في الرأي والتدبير، وبين الجهل في العلم والتصور.
﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ [آل عمران: 67] وكرر ﴿ لا ﴾ لتأكيد النفي عن كل واحد من الدينين، ثم استدرك ما كان عليه بقوله: ﴿ وَلَكِنْ ﴾ [آل عمران: 67] ووقعت لكن هنا أحسن موقعها؛ إذ هي واقعة بين النقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل.
﴿ كَانَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران: 67] الحنيف: المائل عن الشرك والعقائد الزائفة إلى ملة الحق؛ وهي الإسلام.
﴿ مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: 67]؛ لأنهم يعرفون معنى الحنيفية، ولا يؤمنون بالإسلام، فأعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية.
والمعنى: كان منقادًا لله مطيعًا، والحنيفية والإسلام من الأوصاف التي يختص بها كل ذي دين حقٍّ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]؛ إذ الحنيف هو المائل للحق، والمسلم هو المستسلم للحق، وقد أخبر القرآن بأن إبراهيم ﴿ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: 67].
• وفيه الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن «التخلية قبل التحلية»؛ يعني البداءة بالنفي قبل الإثبات؛ فهنا بدأ بالنفي وهو: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ [آل عمران: 67]، ثم أثبت بقوله: ﴿ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: 67]، والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة؛ لأنك تخلِّي الشيء مما يشينه أولًا، ثم تُضيف ما يكون به الكمال ثانيًا؛ وفي حديث الاستفتاح في الصلاة: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد))؛ [مسلم]، فالمباعدة ألَّا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن يُزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف.
﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: 67]، وهذا ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين، ولم يقل: لم يكن مشركًا، فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدًا، لا الشرك ولا غيره، وهكذا ينبغي لكل مؤمن ألَّا يتصف بأي صفة من صفات المشركين، فمثلًا من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد وينكرونه؛ ويقولون: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: 5]، فمن كرِه التوحيد وإن لم يكن مشركًا، ففيه من صفات المشركين، بل قد يكون كافرًا.
ولما كان الكلام مع اليهود والنصارى، كان الاستدراك بعد ذكر الانتفاء عن شريعتهما، ثم نفى على سبيل التكميل للتبرِّي من سائر الأديان كونه من المشركين؛ وهم: عبدة الأصنام، كالعرب الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم، وكالمجوس عبدة النار، وكالصابئة عبدة الكواكب، ولم ينص على تفصيلهم؛ لأن الإشراك يجمعهم.
وقيل: أراد بالمشركين اليهود والنصارى لإشراكهم به عزيرًا والمسيح، فتكون هذه الجملة توكيدًا لما قبلها من قوله: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ [آل عمران: 67]، وليس المراد أن أصل شريعة موسى وعيسى لم تكن صحيحة.
وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة: 135].
﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران: 68] أحقَّ الناس بالنسبة إلى إبراهيم والانتماء إليه وموالاته.
﴿ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ [آل عمران: 68] في زمانه؛ مثل لوط وإسماعيل وإسحاق، وغير زمانه، فيدخل فيه مُتَّبِعُوه في زمان الفترات، وعنى بالأتْباعِ أتباعَه في شريعته.
﴿ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾ [آل عمران: 68]، وخص بالذكر من سائر من اتبعه لتخصيصه بالشرف والفضيلة صلى الله عليه وسلم.
﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران: 68] آمنوا من أمة محمد، وخُصُّوا أيضًا بالذكر تشريفًا لهم؛ إذ هم أفضل الأتباع للرسل، كما أن رسولهم أفضل الرسل.
وفي الآية دليل على أن الأولويات تختلف؛ أي إن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية؛ لقوله: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ ﴾ [آل عمران: 68]، وأولى اسم تفضيل، والتفضيل يدل على المفضل.
ولا شك أن الولاية درجات، فأحق الناس بالولاية الإبراهيمية من اتبعه؛ يعني القوم الذي اتبعوه في عهده؛ لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين، وفي فروع الدين، يعني في جليل الدين ودقيقه؛ ولهذا قدَّم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا؛ لأن نبي الله والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة، بل ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48]، لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام الله عز وجل، وإلا فلا شك أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم، بل وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم.
• وفيه أن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وإن تناءت ديارهم، وتباعدت أقطارهم.
﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّ ﴾ [آل عمران: 68] جميع ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68] تذييل؛ أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، والله ولي إبراهيم، والذين اتبعوه، وهذا النبي، والذين آمنوا؛ لأن التذييل يشمل المذيَّل قطعًا.
فهو سبحانه متولي أمورهم وناصرهم ومجازيهم بالحسنى؛ وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: 257].
وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن يُيَسَّر المؤمن لليسرى، ويُجنَّب العسرى، وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد؛ فالله تعالى ولي كل أحد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 61، 62]، فالله تعالى مولى لهؤلاء وهم كفار، لكن هذا بالولاية العامة، والولاية العامة هي ولاية التصرف، التصرف في الكون والتدبير، والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى، وعليه فإن الله تعالى يعتني به فييسره لليسرى، ويجنبه العسرى.
• وفيه أن كل من كان أكمل إيمانًا، فولاية الله له أكمل وأتم وأخص، هذه فائدة أخذناها من قاعدة معروفة عند أهل العلم؛ وهي: «أن الحكم المعلَّق بوصفٍ يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه»، هذه قاعدة مفيدة، فإذا قلت مثلًا: أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح فهو أحب إليَّ؛ لأن المحبة عُلِّقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح، ازدادت المحبة.
ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته؛ من أجل أن ينال ولاية الله تعالى.
وفيه تعريض بأن الذين لم يكن إبراهيم ليس منهم ليسوا بمؤمنين.
✅ تابعنا الآن عبر فيسبوك – قناة التليغرام – جروب الوتس آب للمزيد من القصص الجديدة يومياً.